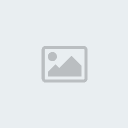.....
ويبين بديع الزمان في رسالة (الطبيعة) بكل وضوح أن جميع المخلوقات في مختلف مستوياتها مرتبطة بعضها مع البعض الآخر بعلاقات متداخلة ومتشابكة كالدوائر المتحدة المركز، أو كالدوائر المتقاطعة،
وهو يشير إلى أن المخلوقات تبدو وكأنها جاءت إلى الوجود من العدم، وفي أثناء حياته القصيرة يقوم كل مخلوق... حسب ما كلف به من وظائف وغايات وأهداف خاصة به ... بوظيفة المرآة التي تنعكس عليها مختلف الصفات الإلهية ومختلف الأسماء الحسنى،
وأن ما يظهره كل مخلوق من العجز، وسرعة الزوال والوجود الطارئ، واعتماده الكلي على عوامل موجودة خارج كيانه ليدل دلالة واضحة لا تقبل الشك أو الجدل بأنه من المستحيل أن يكون هذا المخلوق هو صاحب ومالك هذه الصفات الظاهرة فيه... فإذا كان الأمر هكذا فهو أعجز من أن يهب الصفات الكاملة والزينة والجمال لمخلوقات مثله أو لمخلوقات أكبر منه.
ولكن الماديين ينظرون إلى نفس هذه الأمور نظرة مختلفة ومن زاوية مختلفة، ومع أنهم لا ينكرون النظام والدقة والتناغم في هذا الكون، إلا أنهم يريدون منا أن نؤمن أنه نشأ من حالة فوضى وتشوش نتيجة مصادفة عشوائية، وهم يطلبون منا أيضاً أن نؤمن أن الكون قائم على التفاعلات الميكانيكية للأسباب. ولكن هذه الأسباب... التي لا يعرف الماديون ماهيتها بشكل قاطع... هي نفسها مخلوقة وعاجزة وجاهلة وزائلة ودون هدف...
والماديون يرون أن هذه الأسباب هي التي أنتجت –وذلك من خلال القوانين التي ظهرت من العدم!!– كل مظاهر الدقة والتناغم والتوازن والنظام والجمال التي نراها من حوالينا.
وكما قام إبراهيم عليه السلام بتحطيم الأوثان والأصنام في المعبد، قام بديع الزمان بتحطيم هذه الأساطير والخرافات،
فهو لا يدأب يذكر أنه ما دامت جميع الأشياء يرتبط بعضها مع البعض الآخر، فإن هذا يعني أن من أوجد البذرة هو الذي أوجد الزهرة وأنشأها، وبما أن أحدهما يرتبط بالآخر بعلاقات متداخلة فإن من أوجد الزهرة لا بد أنه هو الذي أوجد الشجرة وأنشأها، ونظرا لوجود علاقات متداخلة فإن من أوجد الشجرة لا بد أنه هو الذي أوجد الغابة وأنشأها... وهكذا إذن فإن القادر على خلق ذرة واحدة يجب أن يكون قادرا على خلق الكون بأجمعه، وهذا ما تعجز الأسباب عن القيام به ولا تطاله أبدا، ذلك لأن الأسباب عمياء وعاجزة وزائلة ومحتاجة وليس لها أي علم بحاجاتنا.
ويوما بعد يوم بدأ العديد من العلماء يدركون أن مساندة النظريات الميكانيكية القديمة لم تعد ممكنة، ذلك لأنه أمام هذا الجمال والروعة وهذا النظام والتناغم والاتساق، وأمام هذا التناظر ووجود الغاية والهدف فإن محاولة تفسير الخلق استنادا إلى فكرة المصادفة والسببية أصبحت –وبتسارع كبير– شيئا لا يمكن الدفاع عنه إلى درجة أن نوبات الهيستريا بدأت تنتاب بعض العلماء الذين بلغ بهم الحنق درجة كبيرة وهم يشاهدون تهاوي آلهتهم القديمة وتحطمها جذاذا.
يقول أحد علماء علم الحياة (البيولوجيا) –والبيولوجيا لا يزال من أكثر فروع العلم ميكانيكية– المشهورين:
– أليس من الغريب أنني كلما اكتشفت جمالا أكثر، وتناسقا أفضل في الكون ازددت قناعة بعبثيته؟!
لا يدرك هذا الرجل المسكين أنه إن كان كل شيء عبثا ودون معنى فإنه وحياته أيضا دون أي معنى.
ويؤكد أيضا عالم آخر مشهور – هل لي أن أقول عنه إنه سيئ السمعة؟– وهو بيولوجي أيضا، بأن وجود الكائنات ولا سيما ظاهرة الشكلPhenomenon of Form لا يمكن عزوها أو إرجاعها إلى الحركة العشوائية للأسباب العاجزة والعمياء والتي لا تملك شيئا من العلم ومن المعرفة. وهو ليس العالم الوحيد الذي يفكر على هذا النحو، ولكنه أول عالم مشهور في العالم الغربي يصرح برأيه هذا بكل صراحة. والذي يلفت النظر أكثر من تصريحه هذا هو قوله أن الجو العلمي في العالم الغربي يشبه نمط إدارة الحكم في عهد بريجينيف.
إن النظرية الميكانيكية اليوم قوية ومسيطرة ومتنفذة في التفكير الغربي –ولا سيما في العلوم البيولوجية– إلى درجة أن جميع العلماء يجب أن ينحنوا أمامها ويستسلموا لها إن كانوا راغبين في الاحتفاظ بوظائفهم.
وهم مضطرون إلى إعلان ولائهم وإخلاصهم لهذه النظرية أمام الملأ، بينما يهمسون بآرائهم الحقيقية في مجالسهم الخاصة، أي يضطرون إلى إدامة هذه التمثيلية وهذه اللعبة.
عندما طبع كتابه الذي هاجم فيه “السببية” وصفت مجلة “نيو ساينتست The New Scientist“ هذا الكتاب بأنه “كتاب يستحق الحرق”، ومنذ ذلك الحين عُدّ هذا الكاتب مؤلفا منبوذا، أي عد “سلمان رشدي” آخر، ولكن في عالم العلم في الغرب.
إن وجود مثل هذه الآراء المختلفة حول سريان أو عدم سريان نظرية الأسباب، والقول بصحة هذه النظرية يشير بوضوح إلى أن عزو قوة الخلق إلى الطبيعة، أو إلى القوانين الطبيعية ليس نتيجة حتمية وضرورية للبحث العلمي الموضوعي، بل هو نظرة شخصية لا أكثر ولا أقل.
ونظير هذا، فإن إنكار خالق الكون –الذي وضع الأسباب الظاهرة، وجعلها ستارا ليد قدرته– ليس نتيجة منطقية وعقلية، بل هو ميل ورغبة نفسية، والخلاصة أن إسناد الخلق للأسباب– أي النظرية السببية – ليس إلا لعبة وحيلة ماكرة وقحة أراد بها الإنسان أن يوزع ملك الخالق بين المخلوقين لعله يبقى المالك المطلق والحاكم لكل ما يملكه، والمالك المطلق لذاته.
ليس في نيتي القيام بتلخيص “رسائل النور” ولكني أريد أن أوضح أن :
هناك مسافة كبيرة بين مفهومي عن الله قبل قراءة رسائل النور وبين مفهومي الحالي عنه – سبحانه– بعد القراءة، فقد أصبحت مقتنعا بأنني عندما أقول: “لا إله إلاّ الله” فإني أكون قد قلت كل ما يجب قوله عن الله تعالى،
لذا فإني مدين بالشيء الكثير لرسائل النور، لقد أصبحت الآن قادرا على فهم أن الله تعالى كان بالنسبة إليّ في السابق شيئاً ضروريا لتكملة الصورة، أو كان هو العامل والسبب غير المعروف الذي يجب وضعه في بداية الخلق لتجنب مشكلة التسلسل اللانهائي. كان بالنسبة لي سابقا “السبب الأول” أو “المحرك الأول”، أي إلها لملء الثغرات، أي شبيها بوضع “الملك الدستوري” لدى الإنكليز، يقدم له أعظم أنواع التوقير والاحترام، ولكن لا يسمح له بالتدخل في شؤون الحياة اليومية.
بينما تشير رسائل النور –التي أَخَذَتْ إلهامها من الآيات الكريمة– أن الكائنات ( التي هي مرايا لأسماء وصفات الله تعالى ) ترينا على الدوام وبأشكال وصور وهيئات مختلفة ومتغيرة
أدلة تقودنا إلى المعرفة
وإلى التصديق
وإلى التسليم،
ثم إلى المحبة
وإلى العبودية،وهكذا ترينا رسائل النور أن هناك خطوات وعمليات محددة يجب إنجازها لكي يكون الإنسان مسلما بكل ما في هذه الكلمة من معنى...
فمن التأمل إلى المعرفة،
ومن المعرفة إلى التصديق،
ومن التصديق إلى الإيمان أو إلى الاعتقاد،
ومن الاعتقاد إلى التسليم.
وما دامت كل دقيقة جديدة، وكل يوم جديد يرينا جوانب جديدة وملامح جديدة من الحقيقة الإلهية فإن هذه العمليات تكون عمليات مستمرة ومتجددة، أي نستطيع القول بأن المظاهر الإسلامية الخارجية (أي أشكال العبادات) ثابتة بينما الإيمان في حركة... أي يزداد أو ينقص، وذلك حسب العمليات التي سبق وأن ذكرتها،
لذا فإن علينا أن نركز اهتمامنا على
حقيقة الإيمان...
هذه الحقيقة التي ستتبعها
حقيقة الإسلام.
لذا فإنني أستطيع أن أقول بأنني كنت مسلما ولكني لم أكن مؤمنا،
وإن ما كنت أحسبه إيمانا لم يكن في الحقيقة إلا عدم القابلية على الإنكار، أي استحالة الإنكار عندي. ومع أن بديع الزمان لم يقدم لي الإسلام– وهذا عمل يستطيع أي شخص القيام به– إلا أنه
قدم لي الإيمان...
الإيمان من خلال البحث والتمحيص وليس من خلال التقليد.
.....